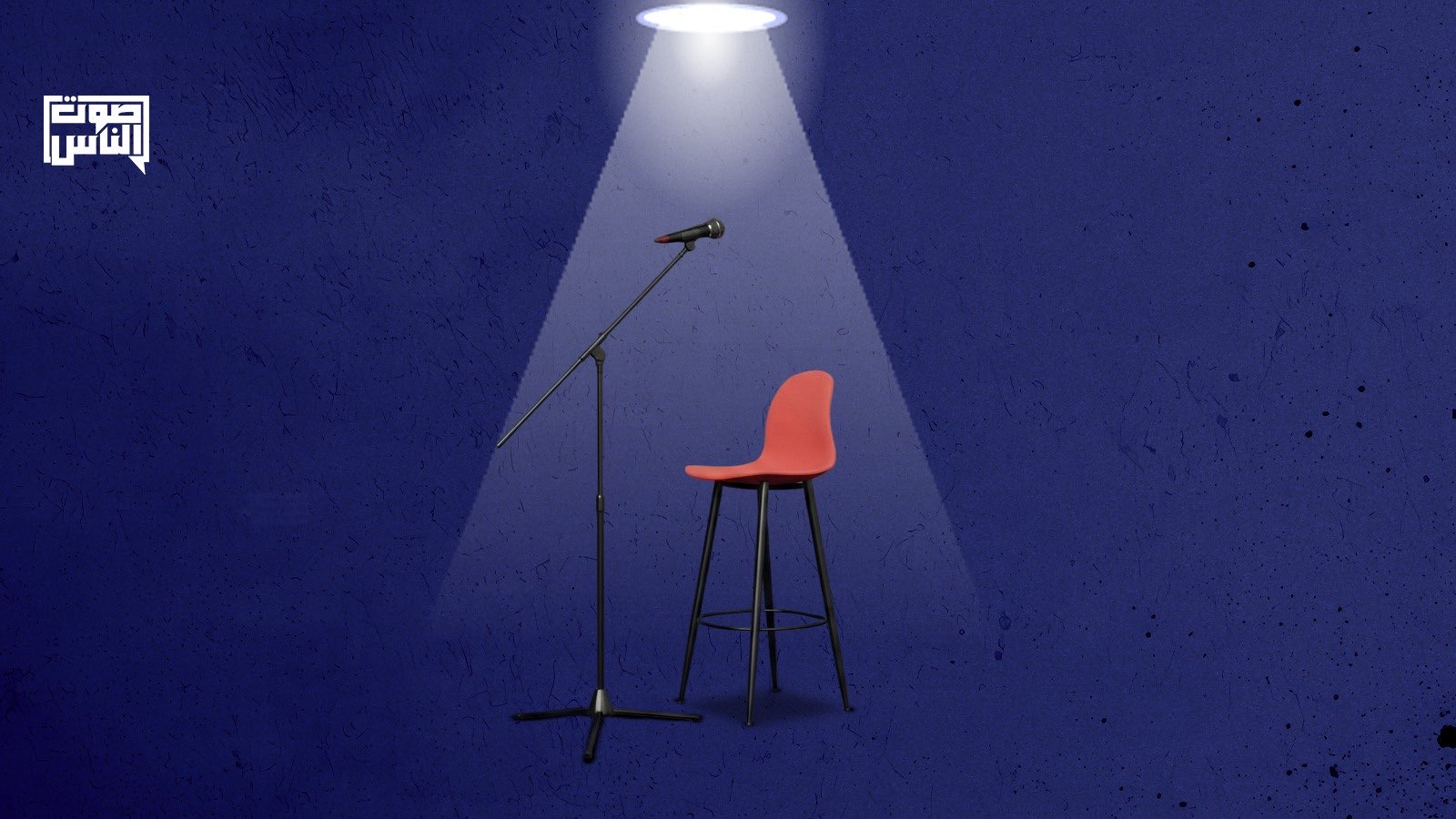مقالات
من يينون إلى توم باراك حين يُصبح التقسيم إسقاطًا على سايكس-بيكو

يبدأ الأمرُ من ورقةٍ ظُنَّت يومًا مجرّدَ رأيٍ في مجلةٍ إسرائيلية متخصّصة، وهي في حقيقتها كاشفٌ لجهازٍ ذهنيٍّ يعمل قبل الأوراق وبعدها. نصُّ «يينون» (1982) ليس «خطةً حكومية» بالمعنى الإداريّ الضيّق، بل بيانٌ مُكثَّف لعقلٍ خرائطيٍّ يرى الأمان في ترتيب الجوار بالخطوط لا بالمعنى، وفي تفتيت القائم إلى وحداتٍ أصغر بدل بناء شرعيّةٍ مشتركة قابلةٍ للحياة. «الأمن عبر التفكيك» لا يقدّم خريطةً فحسب، بل يُعيد تعريف «المشكلة» نفسِها: تصير الدولةُ الوطنيةُ العربية — بما تحمله من كثافةٍ سكانيةٍ وتاريخٍ ورمزية — هي المشكلة، وتُقترَح معالجةٌ تكتيكية: تحويلُ الكتل التاريخيّة إلى فسيفساء إداريّة، عراقٌ ثلاثةُ كيانات، وسوريا ألويةٌ طائفية، ومصر تُضعَّف بتجزيء تماسكها الاجتماعيّ والجغرافيّ. هذه اللغةُ تسمّي نفسَها «واقعية»، لكنها لا تصف محايدةً؛ إنّها تمارس فعلًا: تُسقِف إمكان الاجتماع عند عتبة «قابليّة الإدارة»، وتُنزل الشرعيّة من مقام النِّسبة الحيّة بين الناس إلى ورقةٍ تُكتب بالقلم الأخضر.
ليس المهمُّ مقدار «رسميّة» الورقة في جهاز الحكم، بل أنّها تُفصح عن عقلٍ يعمل في الخلفية: ميزانُه قدرةُ الخطوط على عزل وحداتٍ قابلةٍ للتسيير، لا قدرةُ الناس على عقدٍ عادلٍ يعيد إنتاج نفسه بلا عنف. بهذا المعنى، «يينون» ليس حدثًا منفردًا بل اسمٌ لتيّارٍ معرفيّ: الاجتماعُ يُختزل هندسةً مساحيّة، والشرعيّةُ إدارةً أمنيّة، والمستقبلُ شدًّا وجذبًا بين مربّعاتٍ على سطح الطاولة. وما يبدو «براغماتيةً باردة» هو في جوهره سرديّةٌ تصنع موضوعَها: ما إن تُسمّي مجتمعًا «قابلًا للبلقنة» حتى تُنشئ سياساتٍ تختبر قابليّته إلى أن تُثبتها. والمقصود هنا ليس تعليق التاريخ على نظريّاتِ مؤامرةٍ أو إعفاءَ الداخل من حسابه، بل تسميةُ الجهازِ بأسمائه: استشراقيٌّ خرائطيٌّ يستبدل الاجتماع بالتقسيم، والشرعيّةَ بالإدارة، والمعنى بالصورة؛ ويُقرأ النصُّ بوصفه مرآةً صريحةً لهذا العقل لا «مخطّطًا سحريًّا» يُدار من وراء ستار.
سايكس-بيكو، يينون، باراك: سيرةُ عقلٍ واحد
إذا مددنا الخيطَ إلى الوراء بانَ أنّ «يينون» يفكّر بعقلٍ وُلد زمنَ سايكس-بيكو: لا لتشابه الخرائط وحده، بل لوظيفة الخريطة نفسِها؛ تحويلُ التاريخ إلى خطوط، والسلطةُ إلى هندسةٍ حدوديّة، والاختلافُ إلى تقنيّةِ فصلٍ وتقطيع. لم تكن سايكس-بيكو «مصادفةً دبلوماسية»، بل تدشينًا لجهازٍ يُخضع الأرضَ والناسَ لمنطقٍ فوقيٍّ يُنتج دولةً مسوَّرةً أكثرَ ممّا يُنتج مجتمعًا ذا مقام. هذا «الجهازُ الاستشراقي-الخرائطي» استعادته لاحقًا ورشُ التفكير الأمنيّ بأقنعةٍ شتّى: تتبدّل اللغةُ ويبقى المنطق. فإذا أعياك الخصمُ في مقام المعنى، واجهه في مقام الصورة؛ إن عجزتَ عن كسر الكتلة في روحها، فكسِّرها على الورق وسمِّ ذلك «واقعية».
لا جدوى إذًا من سؤالِ: أهي «خطةٌ رسميّة» أم «مقالُ رأي»؟ المسألةُ أن الورقةَ مرآةُ تصوّرٍ يسبقها ويَلحقها: إحلالُ «الخرائط» محلَّ «المجتمعات»، واليقينُ بأنّ الحلول الكبرى تُصاغ بالمسطرة قبل أن تُصاغ بالعدل. لذلك لم تأتِ جاذبيةُ «يينون» من دقّةِ بنودِها، بل من أنّها أعطت للذهن الإداريّ المولود في لحظة سايكس-بيكو لغةً يقول بها نفسَه دون الاعتراف بأصله: أمنٌ بلا شرعيّة، وترتيبٌ بلا عقد، وهدوءٌ بلا ميزان.
وحين نمدّ الخيطَ إلى الأمام — إلى «توم باراك» وأشباهه — نرى الاستمرار وقد خلع آخرَ محسناتِ القول: ليست هناك «دول» بل «قبائل» و«قرى»، لا «مجتمعٌ سياسي» بل «كتلُ إدارة» تُعاد صياغتُها على مقتضى الصفقة. هنا ينطق الجهازُ الخرائطيّ بلا مواربة: ما يتصوّره باراك عن «الشرق الأوسط» ليس شطحةَ رأسماليٍّ منفعل، بل وعيٌ تجاريٌّ بارد يلتقي العقلَ الأمنيّ في نقطةٍ واحدة: إحلالُ الإدارة محلَّ السياسة، والمعبرُ محلَّ المدينة، والصفقةُ محلَّ العقد. حين يقول «المنطقةُ قبائل»، فهو لا يَصِف «ما هو» بقدر ما يُهيّئ «ما ينبغي أن يكون» كي تعمل أدواتُه بسلاسة: قبائلُ تُشترى ولاءاتُها، خرائطُ تُستبدَل خطوطُها، وأسواقٌ تُفَتَّت لتُدار لا لتَنمو. لا يبتكر «باراك» لغةً جديدة، بل يورِّث اللغةَ التي كُتبت بها الخرائطُ الأولى ويُفعِّل بروتوكولَها عند انسدادٍ جديد.
لماذا تعجز الخطوط عن صناعةِ الشعوب
هذه اللغةُ الواثقةُ بالمسطرة تغفل ما لا يُقاس بالمسطرة: أنّ الخطوط لا تُنشئ شعبًا، وأنّ «الإقليم» ليس سطحَ مرورٍ إداريًّا بقدر ما هو مقامُ معنى تُصاغ فيه النِّسبةُ بين الناس والدولة، وبين الحقّ والقدرة، وبين الذاكرة والمصلحة. لذلك تمسك ورقةُ «يينون» بالقشرة وتفلت اللُّب: تُحسن ترتيبَ السطوح وتفشل في تأليف الأعماق. يمكنك أن تقسِّم جيشًا، وتَشلَّ اقتصادًا، وتقطع طريقًا، وتستبدل علمًا؛ لكنّك لا تصنع بذلك مجتمعًا جديدًا، بل وضعًا إداريًّا لا يحيا إلّا بمزيدٍ من القمع والرِّشى والأوهام.
وما يُقدَّم «حلًا نهائيًّا» ليس إلّا إرجاءً للأزمة وتأجيلًا لانفجارها؛ فالعطبُ ليس في «كبر الكيان» لذاته، بل في غياب الشرعية التي تجعل الكِبَرَ قابلًا للإدارة دون عنف. لذا فإن تفكيكَ الكتلة — متى فُرض خارجَ مقام الشرعيّة — لا يُنهي المعضلة، بل يوزّعها على مربّعاتٍ أصغرَ عددًا وأعلى كلفةً في الصيانة: لكلّ مربّعٍ طغمةٌ جديدةٌ، وحاجزٌ جديدٌ، وقمعٌ جديد. ومن هنا تُقرأ «قسمةُ المقسَّم» مقلوبةً: كلُّ خطوةٍ لإحلال الإدارة محلّ السياسة تُقرّب لحظةَ انكشاف الجهاز، وتُفصح أنّ ما يعمل في الأعماق ليس من صنعِ القلم الأخضر: لغةٌ مشتركة، ومسالكُ حجٍّ وسوقٍ تاريخيّة، وذاكرةٌ تصمدُ في النفوس أكثرَ ممّا تصمد الخرائطُ في الدواوين. هذا المتنُ الحضاريُّ لا يُقاس بالمربّعات، بل يُعاش في نسيج المعاملات والمواسم واللهجات المتداخلة رغم الحدود.
«فرِّقْ تَسُد» هنا ليست حنكةً خارقةً تُثبت نبوغًا استراتيجيًّا، بل علامةَ عجزٍ مُقنَّعٍ يُعوِّضُ فقدانَ الشرعيّة بتكثير نقاطِ الضبط وتوزيع الخوف على مربّعاتٍ أصغر تُدار بالمسطرة واللوائح. ذلك عقلٌ إداريٌّ خالص يخلط الأمنَ بالسياسة ويُنزل الاجتماعَ من مقام العقد إلى سطح الحركة: كيف نُحجِّم الكتلة؟ كيف نُبدِّد طاقتها في خرائطَ صغيرة؟ كيف نُحوِّل المدينةَ إلى معبر، واللغةَ إلى إذن، والاقتصادَ إلى رخصة؟ غيرَ أنّ «تقسيمَ المُقسَّم» ليس ضمانًا لإدامة الشلل؛ فالشللُ لم تُنتجه الخطوطُ بقدر ما صنعته الطُّغَمُ الوكيلةُ التي نُصِّبت بعد الخطوط.
هنا سرُّ النفاذ الحقيقيّ: ليس في براعة التقسيم، بل في استعمارٍ جديدٍ يستبدل الغازي بالمستعمِر المحلّي؛ تبدو السيادةُ وطنيّةً وتبقى آليّاتُ السيطرةِ خارجيّة. طبقاتٌ وسيطةٌ تعمل كبروكسياتٍ لـ«الاستعمار الوطنيّ»: تُؤمِّن السلطةَ للأعلى، وتضمن الريعَ للداخل، وتحوِّل الدولةَ إلى إدارةٍ أمنيّةٍ فوق المجتمع، وتعيد صوغَ الاقتصادِ في شبكةٍ زبائنيّةٍ تكافئ الولاءَ وتعاقب الكفاءة، وتستبدل «المقام» — حيث تعمل النِّسبةُ الحيّة بين الناس والحقّ — بـ«الصورة» التي تُسوِّغها النشراتُ والخطابات. يغدو «التقسيم» مجرّدَ تقنيّةٍ لإدامة عملِ الوكيل لا لحلّ المعضلة، وتنشأ طبقةٌ وظيفتُها حراسةُ الخطوط من الداخل لا بناءُ مجتمعٍ يستغني عن الحراسة.
على هذا القياس، قد ينقلب «تقسيمُ المُقسَّم» — على كلفته ووجعه — إسقاطًا لهذه الطُّغَم أكثرَ منه تثبيتًا لها؛ فحين يُدفَع التقطيعُ إلى مداه يفقد «شرطيُّ الحدود» وظيفةَ الوساطة التي استمدّ منها شرعيّته، ويتلاشى غطاؤه الرمزيّ: لا يعود يعرِّف «المصلحةَ العامّة» ولا يحتكرُ لغةَ الأمن والخدمة. تتّجه الأنظارُ إلى أسفل، حيثُ مؤسّساتٌ أصغرُ بأثرٍ ملموس: بلديّاتٌ تُخدِّم لا تُخرِّج الخطب، تعاونياتٌ تُنتج لا تُثقِل المواطنَ بإتاوات الولاء، آليّاتُ وساطةٍ تُنزِل كلفةَ الخلاف من خطاب «الخيانة» إلى إدارةِ نزاعٍ قابلةٍ للتسوية، وشبكاتُ سوقٍ محليّةٌ تعيد وصلَ المدينةِ بالرِّيف خارج قفص الرخصة السياسيّة.
عند هذه العتبة ينكشف الجهاز: لم تُديروا مجتمعًا بل خرائط، ولم تصنعوا شرعيّةً بل إذعانًا إداريًّا؛ وما حُسِب «استقرارًا» تبيّن أنّه صيانةٌ مُكلِفةٌ لصورةٍ آخذةٍ في التهتّك. التفكيكُ الذي يراهن عليه العقلُ الاستشراقيّ الكولونياليّ ليس مكسبًا صافيًا؛ فما يتفكّك أوّلًا هو «الشكل الإداريّ» المصنوع، وما يعودُ ويتماسكُ بعد كلّ تمزيق هو «المتنُ الحضاريّ» المتجذّر. هكذا قد يغدو «تقسيمُ المقسَّم» — متى توفّرت شروطُه — أكبرَ هديّةٍ لمن يسعى إلى إعادةِ التكوين: يُسقط الوكيلَ، ويكشِفُ الطُّغَم، ويُطلق طاقةَ النهوض من جديد.
ولن نَعُدَّ ذلك «يدًا بيضاء» لأميركا أو لمن يشاطرُها هذا العقل إن وقعوا في الفخّ ودفعوا «تقسيمَ المُقسَّم» إلى حدودٍ تُسقط الوكيل؛ فإن حدث، فليس ثمرةَ بصيرةٍ ولا قصدَ خير، بل طبعُ «حماقةِ الرجل الأبيض»: يتوهّم أنّ إدارةَ السطح تُبدّل المعنى، وأن تضخيمَ الأجهزةِ يُغني عن تأسيس الشرعيّة، ثم يُفاجَأ — رغم كثافةِ مؤسّساته الاستخباريّة واتّساع اختراقه — حين ينهض ما ظنَّه ساكنًا وتتبدّل قواعدُ اللعبة في قلب المشهد. لقد رأيناه يتفاجأ في 11 سبتمبر، ويتفاجأ في 7 أكتوبر، ويتفاجأ كلّما انكشفت الفجوةُ بين ما تُمسكه المسطرةُ وما يتحرّك في الأعماق. تلك هي السيرة: جهازٌ خرائطيّ يسمّي التقطيعَ «واقعيّة»، ثم يُدير أزمةً تتكاثر بتكاثر المربّعات؛ وطُغَمٌ وكيلةٌ تحرس باسم «السيادة» ما لا صلةَ له بالسيادة؛ وناسٌ يطلبون أثرًا لا شعارًا، فإذا انسحبت وظيفةُ الوسيط سقطت معه «هيبةُ الخريطة». لذا تبدو ورقةُ «يينون» مهمّةً لا لأنّها «مخطّطٌ سحريّ»، بل لأنّها مرآةٌ لعقلٍ يظنّ أنّ السيطرةَ على السطح تكفي لتغيير الجوهر — والمرآةُ نافعةٌ لنا نحن أيضًا: تُظهر أنّ مأزقَنا منذ سايكس-بيكو ليس في الخطوط وحدها، بل في تحوُّل الدولة إلى إدارةٍ أمنيّةٍ فوق المجتمع، وفي صناعة طبقاتٍ وسيطةٍ تحرس الخرائطَ أكثرَ ممّا تحرس العقد، وفي تحويل السياسة إلى تقنيّةِ ضبط. وحين تفهم هذا، تفهم لماذا يتكرّر خطابُ «البلقنة» كلّما انسدّ أفقُ الهيمنة: لأنّها الوصفةُ الوحيدةُ لعقلٍ لم يتعلّم غير «فرِّق» ليتوهّم أنّه «سَيَسود».
المعادلةُ المقلوبة
ما يمنح الهيمنةَ نفاذَها ليس التقسيمَ في ذاته، بل دوامُ طبقةٍ وسيطةٍ تحرسه من الداخل. وما يكشفه حديثُ «توم باراك» — وهذا أخطرُ من التوصيف نفسِه — احتقارٌ عميقٌ لِمن يظنّهم «حلفاء»: حين تُسمّى «قبيلة» فلستَ ندًّا ولا شريكًا؛ أنت وحدةٌ قابلةٌ للإدارة والاستبدال على مقتضى الحاجة. والمفارقةُ أنّ هذه الطُّغَمَ الحاكمة — التي يُقذَفُ بهذا الوصف في وجهها — تتأرجح بين لحظتين: لحظةٍ تُصدّق فيها الكذبةَ فتتوهمُ شراكةً في «النظام الدولي»، ولحظةٍ تعرف فيها قدرَها الحقيقي فتُدرك أنّها أداةٌ في يدِ المستعمِر الغازي. ومع ذلك لا تتخلّى عن الدور: أنانيّتُها القبيحة وضيقُ أفقِها ونواياها الرديئة تدفعها إلى قبول الصفقةِ المعلومة: سلطةٌ وثروةٌ وحُكمٌ مقابل وكالةٍ محليّةٍ تُدير الاحتلالَ من الداخل؛ تحرسُ الخطوط، وتؤمِّن المصالح، وتضمن السيطرةَ دون كُلفةِ استعمارٍ مباشر.
هذه الصيغةُ — الاستعمارُ عبر وكيلٍ محلّي — ليست أقلَّ كلفةً بكثير من الاحتلال فحسب، بل أطولُ عمرًا وأشدُّ استقرارًا: حين يكون القامعُ من جلدِ المقموع، وتُمارَسُ السيطرةُ باسم «السيادة الوطنيّة»، يغدو الاحتجاجُ أصعبَ والمقاومةُ أكثرَ التباسًا. والأهمّ أنّ نهبَ الثروات ينتقل من عمليّةٍ عنيفةٍ تستدعي قمعًا دائمًا وتواجه مقاومةً لا تنقطع، إلى نهبٍ «بالتراضي» مُغلّفٍ بعناوينَ برّاقة: سنداتٌ، واستثماراتٌ، وحمايةٌ، واتفاقيّاتُ تعاون. شتّان بين أن تنهبَ ثروةَ شعبٍ وأنت تخشى ثورتَه فتقمعُ مَن يطالبُ باستردادها، وبين أن تأخذَها هادئًا بتوقيعِ حكومةٍ «شرعيّة» تُسوِّغ النهبَ وتسمّيه «شراكةً استراتيجيّة».
لكن إذا دفع «تقسيمُ المُقسَّم» إلى إسقاطِ هذه الطبقةِ وتشظّي وظيفةِ الوكيل، تبدّلت المعادلةُ كلّها: لا يعودُ التقطيعُ عبقريّتَهم بل عُرْيَ نظامِهم، ولا تبقى الخرائطُ أدواتِ ضبطٍ بل وثائقَ اتّهامٍ تُثبت أنّهم لم يملكوا المجتمعَ يومًا، وإنّما اكتفَوا بتحريكِ حواجزِه. عندئذٍ نفهم: مَن يشتغلُ في القشرةِ حتى يُمزِّقَها لا يُنقذُ جوهرَ سيطرتِه بل يُعرّيه؛ ومتى تراجعَ الوسيطُ الوكيلُ حضر سؤالُ الشرعيّةِ من جديد — لا بإذنِ عبورٍ آخر — بل بواقعٍ يفرضُ أن تُرى الخدمةُ والأمنُ والعدالةُ أثرًا لا شعارًا.
إنّ باراك — الجامعُ بين قُبح الخِلقة ومحدوديّة الإدراك وفقر الفكرة — لا يُفاجئنا حين يفضح ضيقَ أفقه وسخفَه وسخفَ مَن أرسله؛ فلا يُفرّق بين الطُّغَمِ الحاكمة والبروكسيّات التي يتسلّط عبرها وبين الشعوبِ التي ابتُلِيَت بها، فيُسقِطُ صورةَ الوكيل على صورةِ الأمّة. ويبلغ به الوهمُ أن يخاطب «قبائل» وهو في الحقيقة يخاطبُ شعوبًا ترجعُ إليها أصولُ الديانتين اللّتين تُقدَّمان في الغرب — ولا سيّما في أميركا ترامب — ركنين لما يُسمّى «الحضارة الغربيّة»: اليهوديّة والمسيحيّة؛ وكلتاهما خرجتا من هذه المنطقة، لا من نيويورك ولا نيوجيرسي ولا لندن ولا برلين ولا باريس.
وعليه أن يعلم — لو كان في وُسعِه علمٌ كهذا — أنّ البديلَ الحضاريَّ الذي ما يزال الشعبُ العربيُّ، ومن ورائه الإسلاميّ، يقدّمه تحت عنوان الإسلام لم يخمد؛ وإن نزل بنا الانحطاطُ الثقافيُّ إلى حدِّ اختزالِ الإسلام في «صيغةٍ سعوديّة» — إذ صار الرسولُ «سعوديًّا»، وليس بعد هذا الانحطاطِ أشدّ — فقد ظلَّ الإسلامُ قادرًا على المنافسة الحضاريّة. بل إنه يخلقُ في أوساطِ اليمينِ الأبيضِ العنصريّ الذي ينتسبُ إليه باراك هوسًا ورُهابًا من الإسلام (الإسلاموفوبيا) يزيدُ حماقتَهم حماقةً وقُبحَهم قُبحًا. وذلك دليلٌ قاطعٌ على أنّ ما يعملُ في الأعماق ليس من صناعةِ الطُّغَمِ ولا من إنتاجِ الوكلاء، بل متنٌ حضاريٌّ متجذّر لا تقيسُه المسطرةُ ولا يبلغه فهمُ باراك وأشباهِه.
وحين يتكلّم باراك بلا حرجٍ عن «قبائل» تُنقَل من مربّعٍ إلى آخر، فإنّه لا يبتكرُ شيئًا؛ إنّما يُورِّثُ اللغةَ التي صِيغَت بها الخرائطُ الأولى، ويُحاولُ تفعيلَ البروتوكولِ نفسِه عند انسدادٍ جديد. غير أنّ هذه اللغةَ لا تملك — ولن تملك — أن تُميتَ ما لا تُميتُه الخرائط: ذلك الحسَّ العميقَ بالوحدةِ الساكنَ لحمَ الأقاليم وروحَها؛ كلّما اشتدّت إدارةُ السطوح عليه عاد يطلبُ تَكوينًا من الداخل لا يُقاسُ بالمسطرة، ويصوغُ شرعيّةً تُرى بالأثر لا بالشعار.
لذلك لا تُقرأ «يينون» قدرًا مُبرَمًا، بل نافذةً تُري أين يعملُ الخصمُ وأين يعجز: يعملُ على السطح — حيثُ الخطوطُ والطُّغمةُ والصفقة — ويعجزُ في المقام — حيثُ النِّسبةُ الحيّةُ بين الناس والمعنى. والنتيجةُ التي نُثبّتُها: ما تصنعُه الخرائطُ قد يُربكُ الدولةَ زمنًا، لكنّه لا يُلغي المجتمع؛ وما يَجنيه التقسيمُ من مكاسبَ أمنيّةٍ قصيرةٍ يستهلكُه — في المحصّلة — عجزُه البنيويُّ عن توليدِ شرعيّةٍ مستدامة. عند اللحظةِ التي تعي فيها الكتلةُ المُمزَّقةُ هذا الفارق، يصير خطابُ «التفكيك» اعترافًا بحدودِ المسطرة، لا وعدًا بقدرٍ جديد.